يعيش اليمن اليوم حالته الأكثر التباسًا منذ قيام الجمهورية. ففكرة الدولة نفسها تذوب بين خرائط الولاء وموازين القوى. كلّ منطقةٍ تدير يومها بطريقتها، ولكلّ طرفٍ ذاكرته الخاصة عن الحرب والسلام. في هذا الفراغ الممتدّ، تُطلّ الأفكار الجديدة عن “دولة جنوبية” أو “إداراتٍ ذاتية” بوصفها محاولاتٍ لتفسير ما لا يُفسَّر.
البلاد تسير بخطى بطيئة نحو واقعٍ تتعدد فيه “الدول” دون أن توجد فعليًا دولة واحدة فاعلة ومتكاملة، وتتعاظم فيه المشاريع السياسية بقدر ما يتقلص الشعور بالوطن. في هذا المناخ تطل التصريحات الأخيرة لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، حول ما سماه “دولة الجنوب العربي” بوصفها تعبيرًا عن فراغٍ وطنيٍّ أكثر مما هي مشروع بديل.
أي خطاب انفصالي في اليمن لا يُعبّر عن طموح سياسي أو جغرافي، لكنه يكشف عن عمق أزمة البلاد التي تحوّلت من حرب أهلية إلى هندسة نفوذ متعدّدة المستويات، تتداخل فيها خرائط السلطة مع حسابات الخارج، والهوية الوطنية مع مشاريع ما بعد الدولة.
هذا النمط من إدارة الصراعات يعبّر عمّا يسميه بعض منظّري العلاقات الدولية “اللا–استقرار المنظَّم”، أي حالة تُدار فيها الفوضى عبر اتفاقاتٍ ضمنية بين القوى الإقليمية، بحيث يبقى النزاع تحت السيطرة دون أن يُحلّ فعلاً. وهو ما يجعل اليمن اليوم ساحة اختبار لتوازنات الخليج وإيران والغرب في آنٍ معًا، لا دولة تبحث عن تسوية وطنية فحسب. بهذا المعنى، يُصبح استمرار الحرب وظيفة سياسية بحدّ ذاته، وليس خللًا عارضًا في النظام العربي.
منذ إعلان الوحدة عام 1990 بين الشطرين الشمالي والجنوبي، لم تُبنَ الدولة على عقدٍ اجتماعي متكافئ، وإنما على معادلة نفوذٍ غير مستقرة. فحرب 1994، التي انتهت بانتصار صنعاء، زرعت بذور الانقسام الذي نضج لاحقًا في مطالب الحراك الجنوبي منذ عام 2007. جاءت ثورة 2011 لتُعيد خلط الأوراق دون أن تؤسّس لبنية مدنية قادرة على احتواء التنوع السياسي والمناطقي، فانهار ما تبقّى من المركز الجمهوري مع تمدد الحوثيين في عام 2014، ومنذ ذلك التاريخ صار اليمن يعيش سلسلة انشقاقات متناسلة تُعيد إنتاج “ما قبل الدولة” في كل مرة.
الزبيدي، في حديثه عن “دولة الجنوب العربي”، لا يخاطب الداخل اليمني بقدر ما يخاطب الخارج، فحديثه عن ضم مأرب وتعز هو في جوهره مناورة رمزية لتوسيع هامش التفاوض، أكثر مما هو طرح جديّ لإعادة ترسيم الجغرافيا. فالجنوب الذي لم يُجمع بعد على هويةٍ واحدة، من حضرموت إلى المهرة، لا يستطيع أن يتحدث عن ضمّ الشمال. ومع ذلك، فإن مجرد طرح الفكرة يعكس نزعة جديدة في الخطاب اليمني تتمثل في انتقال السياسيين من لغة “الوحدة” أو “الانفصال” إلى لغة “المصالح”.
منذ سنوات، لم تعد الحرب اليمنية مجرد صراعٍ بين طرفين، فهي تحوّلت إلى نظامٍ قائمٍ بذاته؛ من اقتصاد حرب، ومراكز نفوذ، إلى مجالس متوازية، وجيوش ظلّ. كل طرفٍ يدّعي امتلاك “مشروع الدولة”، لكن ما يُدار على الأرض هو شكلٌ متجدد من “اللا–دولة”؛ مناطق آمنة نسبياً لكنها بلا سيادة، ومناطق سيادية لكنها بلا أمان. في هذا السياق، يصبح خطاب الزبيدي امتدادًا طبيعيًا لمنطق التعايش مع الانقسام، وليس السعي لإنهائه. فحين يقول إن الجنوب “يحترم إرادة الشماليين”، فهو لا يتحدث عن وحدةٍ ممكنة، بل عن اعترافٍ ضمني بانتهاء فكرة “اليمن الواحد”.
ما يعيشه اليمن اليوم يقترب من نموذج “الدولة الرخوة” بالمعنى الذي استخدمه عالم الاجتماع السويدي غونار ميردال، أي دولة تملك مؤسسات شكلية لكنها عاجزة عن فرض القانون أو إنتاج المصلحة العامة. كما يمكن قراءته في إطار “الدولة الهجينة” التي تتقاطع فيها سلطات رسمية وغير رسمية، حيث تُصبح مؤسسات الدولة واجهاتٍ لتوازناتٍ محلية لا أدواتٍ للسيادة. هذا التحوّل البنيوي يفسّر كيف غدا حضور الدولة في اليمن رمزيًا أكثر منه فعليًا، وكيف أصبح الولاء الجغرافي أو القبلي أو الأيديولوجي بديلًا عن العقد الاجتماعي الحديث.
ربما يحتاج النظام العربي اليوم إلى مراجعة مفهوم “الأمن القومي” نفسه، والانتقال من منطق “الحماية من الخارج” إلى منطق
- التشاركية من الداخل
رغم أن اليمن يقع في قلب المجال العربي والخليجي، فإنّ التعامل معه ظلّ في إطار “إدارة الملف” وليس “حلّ الأزمة”. تعددت المبادرات والوساطات، لكنّها جميعًا بقيت جزئية، تركّز على وقف النار أكثر مما تضع تصورًا لنظام سياسي جديد.
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقدٍ على اندلاع الحرب، لم يعد ممكنًا الركون إلى مقاربة “الدعم من بعيد”، فالتحدي لم يعد عسكريًا بقدر ما هو سياسي وأمني. استمرار الانقسام يعني أن باب المندب، ذلك المضيق الاستراتيجي الذي يمرّ عبره شريان التجارة العالمية، سيبقى هشًّا ومفتوحاً أمام أي نفوذٍ غير عربي.
لذلك فإنّ المطلوب ليس تدخلًا إضافيًا وإنما تنسيقًا حكيمًا، يهدف إلى “تصفير المشكلات” العربية–العربية أولًا، قبل أن تنفجر بؤر النفوذ الإيراني أو تتحوّل إلى ساحة مساومات دولية جديدة.
التجارب السابقة، من العراق إلى ليبيا، أثبتت أن التفكيك لا ينتج استقرارًا بقدر ما يعيد إنتاج الصراع في أشكالٍ جديدة. وإذا لم يُستدرك الموقف بمبادرةٍ سياسيةٍ عربيةٍ شاملة، فستتحول اليمن تدريجيًا إلى “دولة موزاييك” تُدار من الخارج، ويتحول الصراع من نزاعٍ داخلي إلى تنازع إقليمي دائم.
المسؤولية اليوم تقع على النظام العربي الرسمي قبل غيره، فكل تأجيلٍ في بلورة رؤيةٍ مشتركةٍ لليمن هو عمليًا تفويضٌ مفتوحٌ لقوى النفوذ الخارجي كي تدير المشهد. الانفجار لا يحدث بالضرورة على شكل حربٍ جديدة؛ أحيانًا يكفي استمرار الجمود ليبتلع ما تبقّى من الدولة. لهذا فإنّ المطلوب ليس اتفاقاً جديداً بقدر ما هو “إرادة عربية مشتركة” لإغلاق زمن الوصايات المتبادلة.
ربما يحتاج النظام العربي اليوم إلى مراجعة مفهوم “الأمن القومي” نفسه، والانتقال من منطق “الحماية من الخارج” إلى منطق “التشاركية من الداخل”. فالأمن العربي يُبنى على صياغة رؤية مشتركة تُعيد تعريف المجال العربي كفضاءٍ سياسيٍّ وليس كسلسلة أزماتٍ تُدار كلٌّ على حدة.









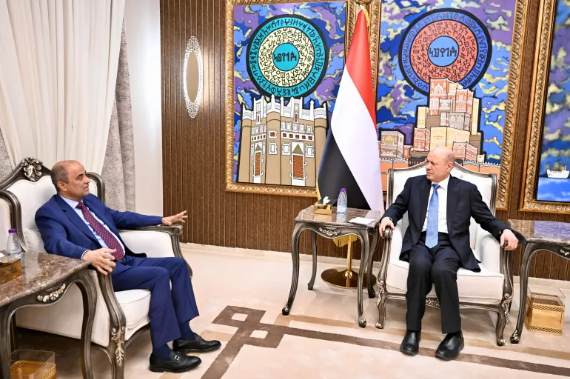

Leave a Reply